المصطفى شقرون
منذ أن رفع الإنسان رأسه إلى السماء وتأمل الوجود، وبدأ يسأل: من أنا؟ لماذا نحن هنا؟ ما هو الخير؟ ما هو الحق؟ ولدت الفلسفة كتعبير عن دهشة الإنسان أمام الحياة والكون.
من شواطئ اليونان القديمة إلى حواضر بغداد وقرطبة، ومن جامعات أوروبا إلى صالونات الفكر في العصر الحديث، قطع الفكر الفلسفي رحلة طويلة وغنية، قادها فلاسفة ملهمون من عصور مختلفة، كان لكل واحد منهم رؤيته الخاصة حول العالم، والإنسان، والمعرفة.
في هذا العرض، سنقوم بجولة عبر مراحل الفلسفة الكبرى، نتوقف فيها عند أهم الأسماء والأفكار، ونحاول فهم التحولات التي عرفها الفكر البشري عبر الزمن.
أولًا: الفلسفة القديمة – ولادة العقل من رحم الدهشة
ظهرت الفلسفة في اليونان حوالي القرن السادس قبل الميلاد، حينما قرر بعض المفكرين التحرر من التفسيرات الأسطورية للكون واللجوء إلى العقل والمنطق.
طاليس رأى أن الماء هو أصل كل شيء.
فيثاغورس ربط بين العدد والوجود.
سقراط دافع عن أهمية معرفة النفس، واعتبر الجهل أصل الشر.
أفلاطون بنى فلسفة مثالية حول “عالم المثل” الذي يتفوق على العالم المحسوس.
أرسطو نظم المعرفة الإنسانية وكتب في المنطق، الأخلاق، السياسة، والبيولوجيا.
ثانيًا: الفلسفة الإسلامية – نور العقل في ظلال الإيمان
في القرون الوسطى، بزغ نجم الفلاسفة المسلمين الذين جمعوا بين الوحي والعقل، وبين الفلسفة والدين.
الكندي دافع عن الفلسفة كأداة لفهم الحقيقة.
الفارابي وضع تصورًا للمدينة الفاضلة، مستلهمًا من أفلاطون.
ابن سينا عمّق فهم النفس والوجود، وميّز بين “الوجود الواجب” و”الوجود الممكن”.
ابن رشد رد على الغزالي في “تهافت التهافت”، وشرح كتب أرسطو، مؤمنًا بعدم التعارض بين العقل والنقل.
الغزالي رغم انتقاده للفلاسفة، دافع عن المعرفة الروحية والصوفية.
ثالثًا: العصور الوسطى المسيحية – الفلسفة خادمة للدين
في أوروبا، ظلت الفلسفة تحت سلطة الكنيسة، وظهر فلاسفة حاولوا التوفيق بين الإيمان المسيحي وفكر أرسطو.
القديس أوغسطين تأمل في الخطيئة والنعمة.
توما الأكويني قال إن العقل يمكنه دعم الإيمان، وليس معارضته.
رابعًا: الفلسفة الحديثة – الثورة العقلانية
مع القرن السابع عشر، بدأت الفلسفة تتجه نحو الإنسان والعقل والتجريب، متأثرة بالعلم الحديث.
ديكارت مؤسس الحداثة، قال: “أنا أفكر إذن أنا موجود”.
جون لوك دافع عن التجربة كأساس للمعرفة.
هيوم حذر من المبالغة في الثقة بالعقل، وشكك في مفهوم السببية.
كانط حاول الجمع بين العقل والتجربة، وأسس ما يُعرف بـ”المثالية النقدية”.
هيجل رأى التاريخ كصراع جدلي يقود نحو الحرية.
خامسًا: الفلسفة المعاصرة – قلق الإنسان وحرية الفكر
في القرن العشرين، انفجرت أسئلة جديدة حول اللغة، السلطة، الهوية، والحياة الفردية.
نيتشه أعلن “موت الإله”، ودعا إلى خلق قيم جديدة.
سارتر فيلسوف الوجودية، قال إن الإنسان مسؤول عن مصيره.
فوكو حلل العلاقة بين المعرفة والسلطة.
دريدا فكك النصوص وبيّن هشاشة المعاني.
راسل وفيتجنشتاين ركزا على منطق اللغة والمعنى.
الفلسفة ليست سجلًا لأفكار منسية، بل هي مرآة لروح الإنسان، وجسر بين الحاضر والماضي، وبين الشك واليقين. من سقراط الذي شرب السم دفاعًا عن فكره، إلى سارتر الذي تحدى عبثية العالم، ظلت الفلسفة صوتًا للحرية والعمق والتساؤل.
ورغم اختلاف العصور، لا تزال الفلسفة تسأل السؤال الأصلي: ما معنى أن نكون بشرًا؟ لذلك، تظل الفلسفة حيّة، ما دام في الإنسان عقل يفكر، وقلب يتساءل، وروح تبحث عن المعنى.

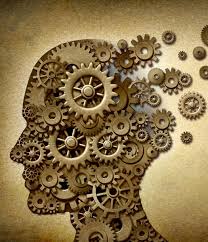









تعليقات
0