المصطفى شقرون
منذ فجر الوعي الإنساني، لم يكفّ العقل عن محاولة فهم العالم وموقع الإنسان فيه. وقد تنوعت أنماط التفكير باختلاف السياقات التاريخية والثقافية، فظهر التفكير الخرافي كاستجابة بدائية للغموض، وبرز التفكير الديني كتفسير غيبي منظّم، وتطور التفكير العلمي كمنهج تجريبي تجزيئي، وارتقى التفكير الفلسفي كأرقى أشكال النظر العقلي المتأمل في الوجود والمعرفة والقيم. فكيف تتمايز هذه الأنماط؟ وأين تتقاطع؟ وما الذي يميز كلًّا منها عن الآخر؟
إلى أي حد يمكن القول إن التفكير الخرافي، والديني، والعلمي، والفلسفي تمثل مراحل أو مستويات متدرجة في تطور الوعي الإنساني؟ وما الذي يميز كل نمط؟ وهل هي أنماط متضادة أم متكاملة؟
1. التفكير الخرافي:
هو أولى محاولات الإنسان لفهم الطبيعة والمصير، ويعتمد على السحر، الأساطير، والاعتقادات الشعبية غير المؤسسة على دليل. يقول أوغست كونت إن “البشر في بداياتهم يفسرون الظواهر تفسيرًا خرافيًا، فيعزون المرض إلى الأرواح والبرق إلى غضب الآلهة”. إنه تفكير يرتكز على العاطفة والخوف أكثر من العقل، وقد يُشكّل أساسًا أوليًا للثقافة لكنه يفتقر للبرهان العقلي أو التجريبي.
2. التفكير الديني:
ينتقل الإنسان من الخرافة إلى نسق إيماني منظّم، يقدم تفسيرًا للكون من خلال وجود قوة غيبية عليا، ويعتمد على النصوص المقدسة، والطقوس، والإيمان. يرى بول ريكور أن “الدين يقدّم رموزًا للمعنى، لا ينبغي تأويلها حرفيًا، بل قراءتها قراءة وجودية”. الدين لا ينافس العلم، بل يقدّم أجوبة عن الأسئلة الوجودية الكبرى التي لا يستطيع العلم الإحاطة بها (الغاية، الأخلاق، الموت…).
3. التفكير العلمي:
هو تفكير يقوم على التجربة، الملاحظة، والاستدلال، ويرفض أي ادعاء غير قابل للاختبار أو التفنيد. يقول كارل بوبر إن “ما لا يمكن دحضه ليس علمًا”. يشتغل على التفسير السببي للظواهر الطبيعية، ويعتمد على قوانين وقواعد قابلة للتحقق. إلا أن مجاله يبقى محدودًا بما يمكن قياسه وتجريبه.
4. التفكير الفلسفي:
هو تفكير عقلاني نقدي تأملي، يتجاوز الوقائع إلى فحص المبادئ، ويطرح الأسئلة بدل الاكتفاء بالأجوبة. يقول كانط: “الفلسفة هي علم المبادئ العليا للمعرفة والفعل”. الفلسفة تُقيم الحوار بين الأنماط الأخرى، إذ تسائل الدين، تنقد العلم، وتكشف أوهام الخرافة. إنها فضاء الحرية الفكرية بامتياز.
ما يطابق بين هذه الأنماط:
جميعها محاولات لفهم الإنسان والعالم.
التفكير الديني والفلسفي يشتركان في السؤال عن المعنى والغائية.
التفكير العلمي والفلسفي يشتركان في استعمال العقل والتحليل المنطقي.
التفكير الخرافي والديني يشتركان أحيانًا في حضور المقدّس والغيب.
ما يفرّق بينها:
المعيار المعرفي: البرهان في العلم، التأمل في الفلسفة، الإيمان في الدين، الاعتقاد غير المبرر في الخرافة.
المنهج: المنهج التجريبي للعلم، المنهج التأويلي للدين، المنهج النقدي للفلسفة، والمنهج الحدسي أو الاعتباطي للخرافة.
الوظيفة: العلم يسعى للسيطرة على الطبيعة، الدين يمنح الطمأنينة الروحية، الفلسفة تسعى للفهم، والخرافة للراحة النفسية أو التبرير.
التفكير الإنساني ليس قالبًا واحدًا، بل فسيفساء من التوجهات والمسارات. من الخطأ النظر إلى هذه الأنماط كخطوط تطورية تصاعدية بالضرورة، إذ لكل منها مجاله وحدوده ووظيفته. غير أن السعي إلى تغليب العقل والنقد والتأمل كما في العلم والفلسفة، هو الضمانة لنهضة فكرية وإنسانية تتجاوز الوهم إلى المعرفة، والتعصب إلى الحوار.
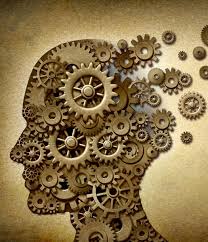










تعليقات
0