المصطفى شقرون
ظل مفهوم الحقيقة عبر العصور من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الفلسفة. يتأرجح تعريفها وطريقة بلوغها بين المنهج النظري العقلي والمنهج التجريبي الحسي. فهل الحقيقة تُدرَك بالعقل الخالص أم بالتجربة؟ وهل يمكن الجمع بين المسلكين في رحلة الإنسان نحو الفهم والمعرفة؟
إلى أي حد يمكن اعتبار الحقيقة نتاجًا للعقل النظري الخالص؟ وهل التجربة الحسية كافية لوحدها لبلوغ الحقيقة؟ أم أن إدراك الحقيقة يقتضي تكاملًا بين العقلي والتجريبي؟
ينقسم الفلاسفة في مسألة الحقيقة بين من يعتمد على العقل كمصدر وحيد للمعرفة، وبين من يجعل من التجربة الحسية أساسًا للوصول إلى الحقيقة.
ففي التيار العقلاني، يرى الفيلسوف أفلاطون أن الحقيقة توجد في عالم المثل، ولا يمكن إدراكها بالحواس لأنها خدّاعة، بل يجب الاعتماد على التأمل العقلي، ويؤكد ذلك في محاورة الكهف، حيث يعتبر الحواس عائقًا أمام بلوغ الحقيقة المطلقة. وعلى نهجه، سار ديكارت، الذي قال: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”. بالنسبة له، الشك هو الطريق إلى الحقيقة، والعقل هو الأداة التي تقود إليها.
أما التيار التجريبي، فقد مثله فلاسفة أمثال جون لوك وديفيد هيوم، حيث يؤمنون أن الإنسان يُولد صفحة بيضاء، وأن كل معارفه تأتي من التجربة. بالنسبة لهم، لا وجود لحقيقة خارج نطاق التجربة الحسية. فـلوك مثلاً يقول: “لا يوجد شيء في العقل لم يكن قبله في الحس.” ويؤكد هيوم أن السبب والنتيجة ليسا سوى عادة عقلية ناتجة عن تكرار التجربة، وليسا قانونًا عقليًا ثابتًا.
غير أن هناك من حاول التوفيق بين النظري والتجريبي، مثل الفيلسوف إيمانويل كانط، الذي رأى أن المعرفة تبدأ بالتجربة، لكنها لا تنبع كلها منها. فالعقل يشتغل على المعطيات الحسية وفق مقولات ذهنية سابقة، ما يجعل الحقيقة نتاجًا لتكامل بين التجربة والعقل.
هكذا يتضح أن الحقيقة ليست مفهومًا بسيطًا، بل نتاج جدل بين ما هو معطى حسّي وما هو مُشكَّل عقليًا. فالعقل يوجّه الحواس، والحواس تغذّي العقل، في تفاعل دائم للبحث عن حقيقة ربما لن تُدرك كاملة، ولكن يُسعى إليها باستمرار.
إن الحقيقة، بين النظري والتجريبي، تبقى فكرة نسبية تتشكل وفق أدوات المعرفة المستعملة. فليس العقل وحده كافيًا، ولا التجربة وحدها صالحة، بل إن الحقيقة تتطلب تضافر الفكر والتجربة، العقل والحس، للوصول إلى تصور متوازن للعالم. إنها مسار لا ينتهي، يتجدد كلما ظن الإنسان أنه بلغ منتهاه.

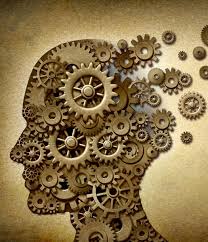









تعليقات
0