المصطفى شقرون ( الحكمة بريس)
يُعد المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء الدول الحديثة، ورافعة حقيقية لتحقيق الديمقراطية والمواطنة الفاعلة. ويثير موضوع البحث في قضايا المجتمع المدني عدة تساؤلات، خاصة حينما يتعلق الأمر بتمييز واضح بين الباحث الذي يستغل موقعه في المسؤولية للحصول على المعلومات بسهولة، وبين الباحث العادي الذي يواجه صعوبات جمّة في الوصول إلى نفس المعطيات، مما يطرح علامات استفهام حول تكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومة.
كيف يؤثر استغلال الموقع الوظيفي في البحث الأكاديمي أو الميداني داخل المجتمع المدني؟ ولماذا يجد الباحث العادي نفسه محاصَرًا بالعراقيل الإدارية والاجتماعية في سبيل الحصول على المعلومة، رغم الشعارات المرفوعة عن الحق في المعرفة والشفافية؟
في العالم المعاصر، صار المجتمع المدني فضاءً رحبًا للمشاركة، والنقد البناء، ومساءلة المؤسسات. غير أن الفجوة تتسع يوماً بعد يوم بين نوعين من الباحثين: الباحث الذي يتمتع بموقع مسؤولية – سواء داخل جمعية، أو منظمة حقوقية، أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية – وبين الباحث الحر الذي يعتمد فقط على كفاءته وإمكانياته الذاتية.
الباحث المسؤول يجد الأبواب مفتوحة أمامه: يمكنه، بصفته، أن يطلب تقارير، أو يحضر الاجتماعات المغلقة، أو يتواصل مع الفاعلين الأساسيين بكل سهولة. في بعض الأحيان، يتم توفير المعلومات له دون الحاجة حتى إلى طلبها، باعتباره جزءًا من الشبكة الداخلية لصنع القرار أو رصد الأحداث.
أما الباحث العادي، فيعيش في عالم آخر؛ يطرق الأبواب فيجدها موصدة، يتواصل مع المسؤولين فلا يتلقى جوابًا، يطلب الوثائق فيُطلب منه اتباع مساطر معقدة قد تستمر أشهرًا، وقد لا تفضي إلى شيء. في مجتمع ما زالت فيه المعلومة تُعتبر نوعًا من السلطة والامتياز، يجد الباحث المستقل نفسه في صراع مزدوج: صراع مع الزمن العلمي، وصراع مع البيروقراطية والثقافة السائدة.
ولعل الإشكال الأخطر يكمن في أن نتائج البحث قد تتأثر بطبيعة العلاقة مع مصدر المعلومة؛ الباحث الذي ينال تسهيلات قد يغفل أو يتغاضى عن بعض الحقائق خدمةً لمصالح الجهة التي سهلت له مأموريته، بينما الباحث المستقل، رغم مصاعبه، قد يكون أكثر جرأةً وموضوعية، لكنه قد يعاني من نقص في المعطيات الدقيقة.
إن هذا التفاوت يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص في البحث العلمي، ويطرح مسألة الحق في المعلومة الذي نصّت عليه العديد من المواثيق الوطنية والدولية، مثل الفصل 27 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
غير أن النصوص شيء، والواقع شيء آخر. فمتى سيتحقق فعلا الحق للجميع، بالتساوي، في الوصول إلى المعلومة دون تمييز أو تمييع؟
يبقى الأمل معقودًا على وعي المجتمع المدني نفسه بخطورة هذا الخلل، وعلى التزام المؤسسات بتفعيل القوانين المنظمة للحق في الوصول إلى المعلومة، بعيدًا عن الامتيازات الشخصية أو العلاقات الضيقة. فلا مجتمع مدني قوي بدون بحث حر، ولا بحث حر بدون مساواة في الحق في المعلومة. إن إصلاح هذا الوضع هو مسؤولية أخلاقية، قبل أن يكون مطلبًا قانونيًا أو أكاديميًا.

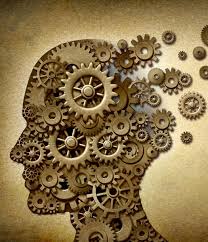









تعليقات
0